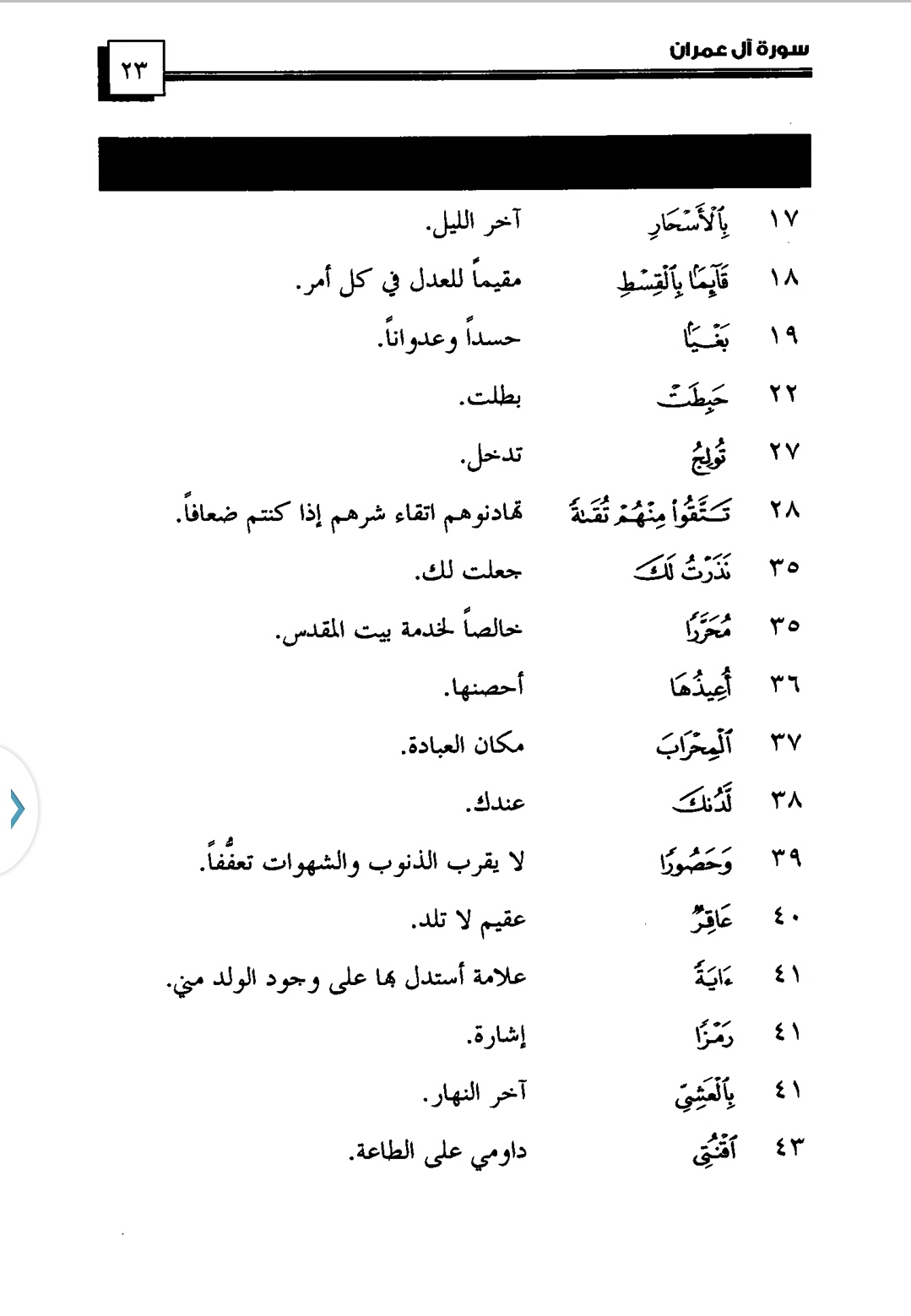د. مساعد الطيار
بِسمِ الله..الحَمدُ لــلِّه والصَّلاة والسَّلام عَلَى رَسُولِ الله....
كُنَّا وقفنا مع قول الله تعالى ( إنَّما يستجيب الذِّين يسمعون والموتى يبعثُهُم الله ثُمَّ إليه يُرجَعُون)
وننتقل إلى الآية التِّي بعدها (وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آَيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)
طبعاً هنا نُلاحِظ أنَّه في القرآن ورَدَ في أكثر من موطن فيها إشارة إلى اقتراح الآيات في السُّورة نفسها في بداية السُّورة كانوا يختلفون في إنزال الآيات. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنَّه حتَّى لو نَزَلَت هذه الآيات فإنَّهم لا يُؤمنُون.
وهنا قال الله (وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آَيَةً) نفس الفائدة سبق أن ذكرناها أنَّ إنزال الآيات إنَّما هُو حقٌّ من حُقُوق الله سبحانه وتعالى بمعنى أنّ المُقترَح ليس هو الأَصل في إنزال الآيات، ولهذا لم يَستجيب الله سبحانه وتعالى للكُفَّار إلاَّ في آية انشقاق القمر على أن يُؤمنوا ولم يؤمنوا. وكان من رحمة الله سبحانه تعالى أنّه لم يُعذِّبهم بالاستئصال بسبب عدم إيمانهم بهذه الآية لأنَّ من يَكفُر من السَّابقين بآية النَّبي فإنّ الله سبحانه وتعالى يستئصُلُهم، ومن رحمة الله أنَّ عذاب الاستئصال لم يقع عليهم .
- تفسير آية (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ )
قال في التفسير الميسر: ليس في الأرض حيوانٌ يَدِبُّ على الأرض، أو طائرٌ يطيرُ في السَّماء بجناحيه إلا جماعاتٌ مُتجانسة الخَلق مثلَكُم ما تركنا في اللَّوح المحفوظ شيءٌ إلاّ أثبتناه، ثمّ إنَّهم إلى ربّهم يُحشرون يوم القيامة فيُحاسِبُ الله كُلاًّ بما عَمِل. والذِّين كَذَّبُوا بِحُجج الله تعالى صُمٌّ لا يسمعون ما ينفعهم . بُكمٌ لا يتكلَّمُون بالحَقّ فهم حَائرون في الظُّلمات لم يــَختاروا طريقة الاستقامة،من يشأِ الله إضلاله يُضلِّله، ومن يَشأ هِدايته يَجعله على صِراطٍ مستقيم. قُـل أيُّها الرَّسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن جَاءكم عذابُ الله في الدُّنيا أو جاءتكم السَّاعة التّي تُبعثون فِيها أغيرَ الله تدعون هناك لكشف ما نزل بكم من البَلاء إن كُنتم مُــحقِّين بِزعمكم أنَّ آلهتكم التِّي تعبدونها من دون الله تنفعُ أَو تَضُرّ. بل تَدعون هناك ربّكم الذّي خلقكم لا غيره وتستغِيثون به فيُفَرِّجُ عنكم البَلاء العظيم النَّازل بكم إن شاء لأنّه القادر على كل شيء وتتركون حينئذ أصنامكم وأوثانكم وأوليائكم. ولقد بعثنا أيُّها الرَّسول إلى جَماعات من النَّاس من قبلك رُسلاً يدعُونهم إلى الله تعالى فكذَّبوهم فابتليناهم في أموالهم بِشِّدة الفقر، وضِيق المعيشة، وابتليناهم في أجسامهم بالأَمراض والآلام رجاءَ أن يَتذَّللوا لِرَبَّهم ويخضعُوا له وحده بالعبادة، فهلاَّ إذ جاء هذه الأُمم الــمُكذِّبة بَلاؤُنا تذّلَّلُوا لنا،ولَكِن قَسَت قُلُوبـِهم،وزيَّن لهم الشَّيطان ما كانُوا يعملون من المعاصي ويأتُون من الشِّرك، فلمَّا تركوا العمل بأوامر الله تعالى مُعرضيِنَ عنها فتَحنا عليهم أبواب كُلِّ شيءٍ من الرِّزق فأبدلناهم بالبأساء رخاءً في العيش، وبالضَّراء صِحةً في الأجسام، استدراجاً منّا لهم حتَّى إذا بَطِروا وأُعجِبُوا بما أَعطيناهم من الخير والنِّعمة، أخذناهم بالعذاب فجأة فإذا هُم آيسُون مُنقَطعون من كل خير.
تعليق الشّيخ: قال الله تعالى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ) وهذا الخِطاب طبعاً للكُفَّار للتَّنبيه على قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولهذا لو أردتَ أن تجمع دوابَّ الأرض -على كثرتها- وتقسِّمها على أصناف الأُمَم كَدابّة مثلاً (أُمَّةُ الثّعالب، أمَّة القِطط، أمّة الفئران، أمّة الأُسود، أُمّة النُّمور ....) وهكذا ستَجد أنّ كُلّ واحدة منها تُعَدّ أُمَم.
(أمثالُكُم) أيّ مِثلكُم في الأُممية (كالفُرس، والرُّوم ، والعرب فيها قبائل ) وهكذا من التَّـفريعات.
/ قال (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) الكتاب المراد به هنا - كما ذهب إليه أصحاب التّفسير الــمُيَّسر- أنّه اللَّوح المحفوظ.
ولفظة الكتاب يدخُلها علم الوُجُوه والنَّظائر بمعنى أنّه قد يَرِد الكتاب في القرآن ويُراد به القرآن كقوله تعالى (الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) فيكون الكتاب هنا هو القرآن . (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) المراد به هنا اللَّــوح المحفوظ، وبعضهم يحمل هذه الآية على أنَّه القرآن، وإن كان القَول فيه ضَعف إلاّ أنَّه يصح بناء على أنّه (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) من أُصول العِلم وليس من فروعه بمعنى أنَّ القرآن يـحمل أصول العلم، وأمَّا فروع العلم فإنّها تُستنبط من هذه الأُصول. وهذه قاعدة كُليّة نبّه عليها الشَّاطبي – رحمه الله – في كتابه ( الموافقات) "أنّ دلالة القرآن على هذه القَضايا دِلالة كُليّة وليست دلالة تفصيلية" فإذا حُمِل على هذا المعنى صحَّ. لكن الصَّواب أنَّه في اللّوح المحفوظ.
/ (ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ) أيّ هذه الأُمم (يُحْشَرُونَ) .
/ قال الله سبحانه وتعالى (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ) لاحظ الآن الأوصاف الثلاث:
(صُمٌّ) أيّ لا يسمعون
(وَبُكْمٌ) أيّ لا ينطِقُون
/ قال (فِي الظُّلُمَاتِ) إشارة إلى العَمى، يعني أنّهُم قد صَارت الظُّلمات ظرفاً لهم أي كأنّهم في وسط الظُّلُمات ولذلك قال (في الظُّلُمات). هم الآن كل مناطق الفهم ومدارك الإحساس قد أُغلِقت عندهم فهم لا يسمعون، لا يتكلمون، لا يُبصرون، هذا من كان في الظُلُمات.
قال (مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) وهذا راجع إلى قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته، وهذا جُزء من آياتِ القَدر، من نَظَر إلى هذه الآية على وجه الإثبات ذهب إلى الجَبر. من حكّم هذه الآية فقط (مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) فإنّه يذهب إلى القول بالجبر. ومن حكَّم آية (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) فإنّه يذهب إلى الاختيار أنَّ العَبد يَـخلُقُ فِعلَه. فيقع التَّـنازع بين أصحاب القَدر - الذِّين يزعُمُون أنَّ العبد يَخُلقُ فعله- وبين أصحاب الجَبر فيكون هناكَ نِـزاع بسبب أنّ هؤلاء أخذوا جُزءاً من الآيات، والآخرون أخذوا جُزءاً آخر فيقع هذا التَّخاصم في معنى الآيات، وهذا وقع كثيراً في طوائف أهل الإسلام.
/ قال (قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ) لم يَدَع لهُم الجواب بل بيَّن سبحانه وتعالى هو الجواب في أنّه لم يقع منهم دعاءٌ إلاّ لله سبحانه وتعالى قال الله (فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ) وهذا مِصداقُه ( فإذَا رَكِبُوا في الفُلكِ دَعَوُا الله مخلصين له الدِّين ) معنى ذلك أنّهم إذا جاءتهم الأزمات فإنَّهم لا يدعُون إلاّ الله سبحانه وتعالى وهؤلاء كُفّار مكّة. وإذا كانوا في الرَّخاء فإنّهم يُشركُون بالله سبحانه غيره - تعالى اللّه عمّا يُشركون- .
/ ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) يُخبر الله تعالى عن سُنّته أيضاً في الأُمم السَّابقة، أنَّـه سبحانه وتعالى أخذ هذه الأُمَم بالفَقَر والشِّدة حتى وصلَ بـِهم الحال إلى حدِّ التَّضَرع، أيّ صاروا إلى مـرحلة من الفقر والفَاقة والشِّدة جعلتهم يتضَّرعون لله سبحانه وتعالى ويطلبونه ويرجُونه، لكن قال الله سبحانه وتعالى (فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا) أيّ هؤلاء أهل مكّة (تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )
/ (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ) لاحِظ الآن هذه المَسألة وهي مسألة مهمّة جِدّاً ويغفل عنها الإنسان أنّ فتح أبواب كُلّ شيء لا يدُلّ على الخير (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ) لاحِظ (بركاتٍ) أمّا هنا قال (فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ) فإذاً المقصد أو المُهمّ بقضيِّة ما ينزل من الله سبحانه وتعالى هو البركة (لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ) فإذا قضيَّة أن يُفتح من السَّماء فقط ليست دِلالة على الخير، ولهذا قال هنا وهو يـختبرهم (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ) وهذه قاعدة أيضاً في أنَّ الله سبحانه وتعالى لا يَبتدء بالإِضلال للعبد وإنـَّما يفتح الله سبحانه وتعالى للعبد ويُريِه النَّجدين -طريق الخير وطريق الشَّر- فإذا سِلَكَ العَبد طريق الشَّر واستمرأ في هَذا الطَّريق واستَّمر فيه، فإنَّ من عقاب الله له سبحانه وتعالى، أن يزيده ضَلالاً في هذا الطَّريق وهذا مصداق الآية (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ) وقع منهم النِّسيان (فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ) فظَنّوا هم هنا الآن أنَّ هذا من نعمة الله (حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمـَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ) .إذاً لو تأمّلنا (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) يعني الزّيغ بدأ من العبد، فلمَّا لــم يرجع العبد ويهتدي ويتوب زاده الله سبحانه وتعالى -والعياذ بالله- زيغاً وهذا من باب الجزاء من جنس العمل فهم لــمَّا نَسُوا الله سبحانه وتعالى فتح الله عليهم أبواب كُلّ شيء حتّى زادوا ضلالاً ، وزدوا بُعداً عن الله -والعياذ بالله - قال (فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ).
- تفسير آية (فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) .
قال في التفسير الميسر: فاستُؤصِلَ هؤلاء القَوم وأُهلِكُوا إذ كفروا بالله وكذَّبُوا رُسلَه فلم يبقَ منهم أحد، والشُّكُر والثَّناء لله تعالى خالِقُ كُلِّ شيء ومالكه على نُصرةِ أوليائه، وهَلاك أعدائه. قل أيُّها الرَّسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن أذهبَ الله سـَمعكم فأصَّمَكم،وذهب بأبصاركم فأعماكم، وطبع على قلوبكم فأصبحتم لا تفقهُون قولاً. أيُّ إلهٍ غيرُ الله جلّ وعلا يقدِرُ على ردِّ ذلك لكم. اُنظُر أيُّها الرَّسول كيف نُنَّوع لهم الحُجَج، ثمَّ هُم بعد ذلك يُعرِضون عن التَّذكُر والاعتبار. قل أيُّها الرَّسول لهؤلاءِ المشركين أخبروني إن نزل بكم عِقابُ الله فجأة وأنتم لا تشعُرون به، أو ظاهراً عِياناً وأنتم تنظرون إليه.هل يُهلَكُ إلاَّ القوم الظَّالمون الذِّين تجَاوَزوا الحَدّ بصرفهم العبادةَ لغير الله تعالى وبتكذيبهم رُسُله. وما نُرسِلُ رُسلنا إلاّ مُبشِّرين أهل طاعتنا بالنَّعيم المقيم، ومُنذِرين أهل المعصية بالعذاب الأليم، فمن آمن وصدّق الرُّسُل وعَمِل صالحاً فأولئك لا يخافون عند لقاء ربّهم، ولا يحزنون على شيء فاتهم من حُظُوظ الدُّنيا. والذِّين كذَّبوا بآياتنا من القُرآن والــمُعجزات فأولئك يُصيبُهم العذاب يوم القيامة بسببِ كُفرهم وخُروجهم عن طاعة الله تعالى.
تعليق الشيخ: قوله (فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) هذه خاتمة لقوله (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ * فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) الدَّابِـر هو: آخر شيء كأنَّـه قـد أتى هذا العَذاب واستأَصَل أوَّلهم حتى وصل إلى آخرهم فقَطَعَ دَابرَهُم فلم يبقَ منهم أحد.
وقال (فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا) وهو يتكلَّم عن قومٍ سَبَق الحديث عنهم في قوله (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ) فلم يقُل "فَلمَّا نسُوا الذِّين ظَلَمُوا ما ذُكِّروا به" فجاء به على الضَّمير، فلمَّا جاء عند هذه الآية قال (فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ولــم يقل "فقُطِعَ دابـِرهم وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" وهذا نوعٌ من الاستطراد وهو إظهارٌ في مَقَام الإِضمار للتَّنبيه على سبب من أسباب نزُول هذا العذاب بهم، ما هو سبب نُزول هذا العذاب بهم؟ أنَّـهم قومٌ ظلموا، فإذاً ظُلمهم كان سبباً من أسباب العذاب، لا يَتأتَّى فهم هذا لو كانت "فقُطِعَ دابرهم والحمدلله ربِّ العالمين".
القَضيِّة الثّانية: أنَّ الله سبحانه وتعالى أثبت حمده بعد قطعِ دابر الذِّين ظلموا، لأنَّ الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال وهؤلاء القَوم الذِّين ظلموا لم يحمدوا الله سبحانه وتعالى فلم يقَع الحمد التَّام إلاَّ بزوال هؤلاء القَوم الذِّين ذكرهم الله سبحانه وتعالى.
ونُلاحظ أنَّ المقطع (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) هو نفس المقطع الذِّي ابتدأت به سُورة الفاتحة على القول أنَّها تبتدأ بـ (الحمدلله ربّ العالمين) وهو القَول الأصَحّ.
طبعاً (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) تكرَّرت في القرآن في غير ما موطن.وجُعِلَ (الحَمدلله) يعني مِلكاً، أيّ الحمدلله لا غيره، الموصوف بأنّه ربّ للعالمين لأنَّها بدل من لفظ الجلالة.
• والعالَمِين هنا المراد بهم جميع العوالم كما قال علي بن أبي طالب: كُلّ من سِوَى الله.
وأيضاً العالَمِين وردت في القُرآن والمُراد بها المكلَّفين فيكون للعالمين أكثر من وجه:
في قول سبحانه وتعالى (إن هو إلاَّ ذكرٌ للعالمين) ولا يكون ذِكراً إلا للمكلَّفين من الجِنّ والإنس هنا فيكون ذكر للعالمين أي المكلفين من الإنس والجن. فيأتي العالَمِين والمراد بهم الجِنّ والإنس، ويأتي العالمين والمراد بهم كل من سوى الله سبحانه تعالى فيدخل فيهم الجِنّ والإنس.
/ قال (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ) هذا تهديد
(وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ) يعني الآن لو تأملت تصريف الآيات في القرآن التي طلب الله سبحانه وتعالى من الكفار أن يتأملوها ليُؤمنُوا به سبحانه وتعالى ستجد أنَّها كثيرة، وأنّها متنوعة، مرَّةً في النّبات، ومرَّةً في الحيوان، ومرَّة في الإنسان، ومرَّةً في الأحوال، تصريف الآيات بشتّى الطُّرُق لأجل أن يُؤمِنَ هؤلاء القوم ومع ذلك لم يُؤمنوا يعني ممَّن مات منهم كافراً فالله سبحانه وتعالى يقول هنا (انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ) .
فإن أخَذَ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، إذا أخذ السمع إذاً أُغلِقَت أحد منافذ العَقل. أُخِذ البصر أُغلِق المنفذ الثاني للعقل. إذا خُتِمَ على القلب انتهى. يعني تصَوَّر أنت الآن إنسان لا يسمع، لا يُبصر، ليس له قَلب، هذا هو قَلب الكافر ولذلك قال (وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ).
/ (قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ) وكُلَّها تذكيرات لهؤلاء الكفّار-كُفَّار مكَّة- الذِّين كانوا مُعَاندين للنَّبي صلى الله عليه وسلّم لأنّ هذه السُّورة – كما تعرفون – سورة مكيّة ولعلّ يأتينا ما قيل في أنها نزلت دُفعة واحدة.
/ قال (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ )
هذه آية من آيات التَّبشير،الآن لاحظ المقام الآن في الحديث مع الكُفّار وقدَّم البِشارة وهذا من باب التَّصريف أيضاً، تقديم البِشَارة هنا مع أنَّ النَّاظر لأوَّل وهلة يقول مادام الخطاب مع الكُفَّار وذكر هذه الآيات الشَّديدة الكبيرة جِدّاً التّي تدُل على ما لهم من عقابات لِمَ لم يُقدّم الإنذار قبل التَّبشير لأنّ الإنذار يتناسب مع حال الكُفّار، فيكون هذا الجَانب مع ما ذُكر من هذه الجوانب أنّه جانب ترغيب، بعد ذكر هذه الآيات الشّديدة الدَّالة أنّ الله تعالى يقطع دابر الكُفّار قال (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ) وهذا هو الأصل فيهم، ثم قال (وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ) أيضاً لاحظ فيه اللَّف والنَّشر المُرتَّب: (فَمَنْ آَمَنَ وَأَصْلَحَ) يُناسبه البشارة، (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا) يُناسبه النِّذارة. هذا أيضاً من أنواع اللَّف والنَّشر الــمُرَّتب. ثمّ أنّه قال في وصفهم أولاً في الآيات السّابقة (فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا) وهنا قال (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ) وصف آخر لهم. في الأوَّل قال (الذِّين ظَلموا) وهُنا قال (بما كانُوا يفسُقُون).
ومجِيء (كانُوا) هُنا للدِّلالة على تأصُّل الفِسقِ فِيهم.فإذا جاءت (كان) للدِّلالة على تأصُّل هذا الفِعل فيمَا بعده.
وقوله (بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ) للدّلالة على تأصُّل الفِسق فيهم.
قوله (بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ) ولم يقُل "بما فَسَقُوا" للدَّلالة عَلى تأصُّل الفِعل من جهة الفعل الماضي (كان)، والتَّجدُد في كلمة (يفسُقُون) من جهة أخرى في خاتمة الآية.
- تفسير آية (قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ...)
قال في التَّفسير الميّسر : قل أيُّها الرَّسُول لهؤلاء المشركين إنّي لا أَدَّعي أنِّي أملك خَزائن السّموات والأرض، فأتصَرّفُ فيها، ولا أدَّعي أنّي أعلم الغيب ولا أدَّعي أنّي مَلَك. وإنِّما أنا رسول من عند الله، اتّبِع ما يُوحَى إليّ وأُبّلغ وحيَهُ إلى النَّاس،قل أيُّها الرَّسول لهؤلاء المشركين هل يستوي الكافر الذّي عَمِيَ عن آيات الله تعالى فلم يُؤمن بها،والمؤمن الذِّي أبصر آيات الله فآمن بــِها أفلا تتفكرون في آيات الله لتُبصُروا الحقّ فتُؤمنوا به، وخَوِّف أيُّها النّبي بالقرآن الذِّين يعلمون أنَّهم يُحشرون إلى ربِّهم، فهُم مُصَّدَقُــون بوعد الله ووعيده، ليس لهم غيرُ الله وليٌّ يَنصُرُهم ولا شفيع يشفع لهم عنده تعالى فيُخَلّصهم من عذابه لعلّهم يتَّقون الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النَّواهي. ولا تُبعِد أيُّها النَّبي عن مجالستك ضُعفاء المسلمين الذِّين يَعبدُون ربّهم أوَّل النَّهار وآخره، يُريدون بأعمالهم الصَّالحة وجه الله، ما عليك من حِساب هؤلاء الفُقراء من شيء إنَّما حسابهم على الله، وليس عليهم شيءٌ من حسابك فإن أبعدتهم فإنَّك تكون من المتجاوزين حدود الله، الذِّين يَضَعُون الشّيء في غير موضعه.
تعليق الشّيخ: قوله (قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ) يعني قل يا محمّد لهؤلاء القوم المشركين الكُفَّار، إنّي (لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ) أيّ لا يدَّعِي محمد صلى الله عليه وسلّم ما ليس له، ومع ذلك نجِد أنَّ بعض من انحرف يَدَّعي له ما نفاهُ الله سبحانه عنه.
(وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ) إلا بما يُخبره الله تعالى به.
(وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ) لستُ مَلَكاً من الملائكة، كُلّ هذه لم يدَّعها النّبي صلى الله عليه وسلم.
/ قال (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ) إذاً مهمّة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم هي فقط التَّبليغ ولهذا قال الله (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ) الأعمى يُمثِّل الكافر، والبصير يُمثّل المؤمن. هل يستوي المؤمن والكافر؟ الجواب: لا.
في قوله (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ) هذا يدُلّ على أنّ ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلّم الأصل أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم هو وحي، لكن إذا وقع منه صلى الله عليه وسلّم اجتهاد يُخالف ما أراده الله سبحانه وتعالى.
فالسُّؤال هنا: هل الله سبحانه وتعالى يسكُت عن اجتهاد النّبي؟ أم أنّه جلّ وعلا يُخبر نبيِّه ؟ الجواب: أنّه يُخبره، وهذا نوع من العِصمة لنَبيّه قد يُغفل عنه، وهو أنّ النَّبي إذا وقع منه خطأ ما يُخالف ما أراده الله سبحانه تعالى فإنَّ من عصمة الله تعالى له أنّه يُخبرُهُ. هذا نوع من أنواع العِصمة لا يتأتَّى لغير النَّبي. الآن نحن نقع في أخطاء هل يخبرنا أحد أننا أخطأنا أو ما أخطأنا؟ الجواب: لا. لكن في حقِّ الأنبياء لا، لو وقع منهم خطأ فإنّ الله سبحانه وتعالى يُنبّههم على هذا الخطأ، فيُخبِرهُم به فيستغفرُون فيغفر لهم . مثلما قال في قصّة داوود عليه الصلاة والسلام بعد أن قال ( فغفرنا له ذلك) وأيضا في قصِّة سليمان وفي غيرها من القَصص كلُّها يُخبِر بما حصَل من النَّبي ثُمّ يُخبِر بتوبة هذا النَّبي ، ثُمَّ يُخبِر بمغفرته سبحانه وتعالى.
فإذاً المقصود من ذلك: أنّ الأصل في النَّبي أنّه يتبّع ما يُوحى إليه فلو وقع منه ما يخُالف ما يريده الله فإنّ الله سبحانه وتعالى يُخبره ويُصحِّح له هذا الأمر، فإن لم يُخبره فهو دلالة على صحة ما جاء به صلى الله عليه وسلّم.
/ قال (وَأَنْذِرْ بِهِ) أيّ أنذر بالقرآن (الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ) يعني أنذر به المؤمنين كما قال ( هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ) فَهُم الذِّين يخافون أن يُحشَروا إلى الله أمّا الكُفَّار فإنّهم لا يُؤمنون بالبعث ولذا لا يخافون أن يُحشروا إلى الله.
/ قال (وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) هذه نزلت في مكّة، أيَّام كان النّبي صلى الله عليه وسلّم ليس عنده إلا الضُّعفاء وكان النّبي صلى الله عليه وسلّم يرجو ويترقَّب إيمان بعض الكِبَار من مكّة، فكانت هناك مُوازنات فنبَّه الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر أنَّه هل يُؤخَّر هؤلاء الضُّعفاء مثل صُهيب الرُّومي، وبلال وغيره ويَستدني هؤلاء الكِبار رجاء إسلامهم؟ أوّ أنّه يُبقي هؤلاء؟ فجاء الأمر الإلهي (وَلَا تَطْرُدِ) حتى لاحِظ العبارة فيها ثِقل (وَلَاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ) أيّ لو وقع أنَّ النّبي صلى الله عليه وسلّم طَردهم لكان من الظّالمين – وحاشاهُ – أن يفعل هذا لـــــمَّا أخبره الله سبحانه وتعالى. وإلاّ نحن نعلم أنَّه وقع في بعض الآيات أنَّ بعض المشركين قال : لو أنَّك أبعدتَ هؤلاء لجِئنا مجلسك. يعني كيف نجلس نحنُ السَّادة مع هؤلاء وهم في حكم العبيد. فالله سبحانه وتعالى نهاهُ عن أن يفعل هذا الفعل. لأنَّه قد يرى الرسول صلى الله عليه وسلّم أنه من مقتضى المصلحة أن يُؤّخر هؤلاء، ويستدني هؤلاء رجاء إسلامهم، ولذلك جعل الله الأمر حتماً واحداً أنّه لا يفعل هذا الفعل.
- تفسير آية (وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ....)
قال في التّفسير الميّسر: وكذللك ابتلى الله تعالى بعض عباده ببعض، بتبَاين حُظُوظِهم من الأَرزاق والأخلاق فجعل بعضهُم غنيّاً وبعضهُم فقيراً،وبعضهُم قويّاً وبعضهم ضعيفاً فأحوَجَ بعضَهُم إلى بعض اختباراً منه لهم بذلك، ليقولَ الكافرون الأغنياء أهؤلاء الضُّعفاء منّ الله عليهم بالهداية إلى الإسلام من بيننا. أليس الله تعالى بأعلم بـِمَن يشكرون نعمته، فيُوَّفقهم للهداية لدينه، وإذا جاءك أيُّها النّبي الذّين صدَّقوا بآيات الله الشَّاهدة على صِدقِك من القرآن وغيرهم، مستفتِين عن التَّوبة من ذُنوبهم السّابقة فأكرمهم بردّ السّلام عليهم، وبشِّرهم برحمة الله الواسعة فإنّه جلّ وعلا قد كتب على نفسه الرّحمة بعباده تفُضُّلاً أنَّه من اقترف ذنباً بجهالة منه لِعَاقبتها وإيجابها لسَخَطِ الله، فكلُّ عاصٍ الله مخطئاً أو متعمّداً فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالماً بالتَّحريم، ثم تاب من بعده وداوم على العمل الصّالح فإنّه تعالى يغفر ذنبه، فهو غفور لعباده التّائبين، رحيمٌ بهم.ومثل هذا البيان الذّي بينَّاه لك أيُّها الرّسول نُبيِّن الحُجج الواضحة على كُلِّ حقّ يُنكره أهل الباطل ليتبيَّن الحقّ ، ولِيَظهَر طريق أهل الباطل المخالفين للرُّسل.
تعليق الشيخ: قال ( وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) يعني فتَّنا السَّادة بالعبيد، وفتَّنا العبيد بالسَّادة.
/ (لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا) أيّ ليقول هؤلاء السَّادة (لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا) يعني ما كان الإسلام ولا كان الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن يأتي إلاَّ من هؤلاء قَبلنا، فهذا لا شك أنه نوع من فتنة، فقال الله (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ).
/ ثم قال الله (وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِنَا) أَيّ هؤلاء الضُّعفاء (فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ) وانظر إلى لُطف هذا التَّعبير (وإذا جاءَكَ الذِّين يُؤمنُون بآياتِنا فقُل سلامٌ عليكم كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) هذا اللُّطف في الخِطَاب وهم جَاؤوا يسألون عن الذَّنب إذا وقع منهم ماذا يحصُل؟ فالله سبحانه وتعالى قدَّم قبل فتواهم وسؤالهم قال (وإذا جاءَكَ الذِّين يُؤمنُون بآياتِنا فقُل سلامٌ عليكم كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ). قولُه (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) هذه مقدِّمِة للجواب. قال (أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ) وكُلّ من عَمِلَ السُّوء حتَّى ولو كان عالماً فإنّه حال عمله بهذا السُّوء فإنَّه يعتبر جاهلاً كما ذكر ذلك ابن عبّاس رضي الله عنهما.
/ قال (ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ) أيّ عمل السُّوء ثمّ تاب (وَأَصْلَحَ ) أيّ أضاف إلى توبته زيادة إصلاح (فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) أيّ يُوقِع مغفرته ورحمته على عبده. وهذا من تمام كرم الله سبحانه تعالى وتحبُّبه إلى عباده في أنّه ما جعل ذنباً إلاّ وله توبة. وقد أخبر النّبي صلى الله عليه وسلّم عن الرّجُل يُذنب ثم يتوب، يُذنب ثمّ يتوب، يُذنب ثمّ يتوب -وطبعا توبته تكون صادقة وليست توبةً كاذبة- فإنّ الله يُطلِع الملائكة يقول: قد علم عبدي أنّ له ربّاً يغفر الذَّنب، قد غفرتُ لعبدي فليعمل ما يشاء. مثل هذا هو نوع من توسيع رحمة الله تعالى لعباده.
نحن الآن لو تأمّلنا هذا الأسلوب في الآيات: لاحظوا الآن جاء هذا وهو مُذنب انتهى. ماذا تقول له؟ كيف تتعامل معه؟ كيف تُرشده إلى التَّوبة؟ (سلامٌ عليكم كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) ثمّ بعد ذلك تقول من تاب وأصلح فإن الله غفور رحيم .
هل نحن بالفِعل حينمَا يأتِينا المذنب، أو يكون هناك من هو مُذنِب نتعامل معه بهذا الأُسلُوب؟
هذا لا شَك نوع من التّربية نحتاج إلى أن نتأمَّله وأن نتبنَّه له، لأنَّه قد يقع مِنَّا خِلافَ ذلك ولكنَّه ليس هو الأسلوب الأنجع، هذا هو الأسلوب الأنجع ، الأسلوب الذّي أنزله الله في كتابه.
/ قال (وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ) أي تظهر وتتضَّح سبيل المجرمين. أغلب الآيات السّابقة كانت مع هؤلاء المجرمين مع الكُفّار، فهذا الإيضاح بعد الإيضاح بعد الإيضاح وما يمكن أن نُسمِّيه (تصريف القول) أيّ أنه يذكر الشيء مرّة بعد مرّة بعد مرّة، كلُّه لكي تستبين سبيل المجرمين وتكون ظاهرة وواضحة.
السُّؤال أيضا الذِّي يرد: هل نحن من خلال قِراءتنا للقرآن تستبين لنا سُبُل هؤلاء المجرمين؟
حينما نقرأ في الصُّحُف،حينما نقرأ في الكُتُب، حينما نُطالِع شيئاً ما في تلك الشَّاشات، أوفي الإنترنت، هل نحن نعلم أنّ هذا هو سبيل المجرمين وأنّهم يستخدمون هذا السَّبيل الإِجرامي أو لا؟ أو نحنُ مـِمَن تنطلي عليهم هذه السُّبُل ولا ننتبه لها؟ هذه قضيّة لا شك أنّها بحاجة إلى أن يكون المسلم واعياً من خلال هذا الكتاب. وأنا على ثقة كبيرة جِدّاً أنّه لو واحد منّا قرأ بهذا النَّفَس وحاول أن يستشهد لهذه الآيات بما يراه من الواقع -وإن أخطأ مرة أو مرتين أو ثلاث- لكن سيكون له دِربَة في أن يعرف بالفعل ما هو سبييل المجرمين الذّي يراه اليوم ظاهراً وماثلاً في أمثلة كثيرة من أعمال الشَّر التّي نراها.
- تفسير آية (قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ)
قال في التّفسير الميّسر: قل أيُّها الرسول لهؤلاء المشركين إنَّ الله عزّوجل نهاني أن أعبد الأوثان التِّي تعبدونها من دونه، وقل لهم لا أتّبع أهواءكم قد ضللت عن الصِّراط المستقيم إن اتَّبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين. قل أيُّها الرّسول لهؤلاء المشركين إنّي على بصيرةٍ واضحةٍ من شريعة الله التّي أوحاها إليّ، وذلك بإفراده وحده بالعبادة وقد كذَّبتم بهذا. وليس في قُدرتي إنزال العذاب الذّي تستعجلون به، وما الحُكم في تأخُّر ذلك إلاّ إلى الله تعالى يقُص الحقّ وهو خير من يفصل بين الحقّ والباطل بقضائه وحُكمه.
تعليق الشيخ: (قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) وهذه الآية شبيهة بآية (قُل يا أيُّها الكَافرون*لا أعبد ما تعبدون).
(قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) وهذه أيضاً قاعدة في التَّعامل مع الكُفَّار وهو أنَّ اتَّباع أهواء الكُفَّار لا شَكَّ أنّه يُردِي المسلمين، ولذا يجب على المسلم أن يكون حَذِراً من أهواء الكُفَّار.وأنتم تُلاحظون اليوم أهواء بعض الكُفّار الذِّين يأتُون إلى بلادنا ويُقيمون أحياناً ندوات في سَفَاراتهم أو غيرها ويَدعُون أبناء هذا البلد لأن تعمل المرأة، وأن يفعلوا بالمرأة، ويجب على المرأة أن تفعل كذا، ويجب عليكم أن تفعلوا كذا. كُلّ هذا من أهواء القوم الذِّين ضلُّوا. ولهذا الله سبحانه تعالى يُحذّر (قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) فإذاً عندنا قاعدة أنَّ اتّباع أهواء الكُفّار يُوصِل إلى الضَّلال بلا ريب، ولا يمكن بحال أن يوصِل الكافر المسلم إلى الخير،لا يمكن، الكفر والإسلام نقيضان .
فلا يُتصوَّر أن يكون الكافر مُوصلاً الهدى والخير للمسلم البتّة وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى إن اتبعت أهواءهم فإنك تضِل ولا تكون من المهتدين.
/ قال (قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ) وهذه الحقيقة الآية أيضا نفس المعنى الذي سبق وذكرناه وهو وضوح الحقّ مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضوح الحقّ عند أهل الحقّ (إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي) على أمرٍ واضحٍ ليس فيه أيّ شكّ أو ريب.
/ قال: (وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ) يعني أن الأمر كُلُّه لله إن شاء عجّل العذاب وإن شاء أخّره ولذلك (قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ) معنى ذلك أنّ الأمر ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم وإنَّما هو لله تعالى وهو سبحانه أعلم بالظالمين.
ولعلَّنا نقف عند هذا ثم نختم إن شاء الله في اللِّقاء القَادِم
سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرُكَ ونتوب إليك.
المجلس الثَّاني
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم والصَّلاة والسَّلام على أشرف خلق الله أجمعين, اللهُمَّ اغفر لنا ولشيخنا أجمعين.
قراءة من التفسير المُيسر: تفسير قول الله عزَّوجل: (قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الأَمْرُ...) قُل يا أيَّها الرَّسُول لو أننَّي أملكُ إنزال العذاب الذِّي تستعجلونه لأنزلتُهُ بكم وقضي الأمر بيني وبينكم ولكنّ ذلك إلى الله تعالى وهو أعلمُ بالظَّالمين الذِّين تجاوزوا حدّه فأشركوا معه غيره,وعند الله جلّ وعلا مفاتح الغيب أي ّخزائنُ الغيب لا يعلمها إلا هو , ومنها علم الساعة، ونزول الغيث، وما في الأرحام والكسب في المستقبل، ومكان موت الإنسان، ويعلم كل ما في البرّ والبحر, وما تسقط من ورقةٍ من نبتة إلا يعلمها, فكل حبةٍ في خفايا الأرض وكل رطبٍ ويابس مُثبَتٌ في كتابٍ واضح لا لبس فيه وهو اللَّوح المحفوظ.
تعليق الشِّيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , هذه الآية في قوله (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ) وهي مفاتِح الغَيب الخمسة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: مفاتح الغيب خمس ثم ذكر آخر سورة لقمان.
/ قال: (وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) أصلاً كل ما في الأرض إما برّ وإما بحر, أي يعلم كل ما في البرّ وكل ما في البحر, ذكر الله سبحانه وتعالى من دقيق علمه مثالاً قال: (وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا) أنت مثلاً في وقت الخريف -طبعا ما يمرّ علينا الخريف- لكن في وقت الخريف تتساقط الأوراق، اجلس أنت فقط خمس دقائق أمام هذه الأشجار، وانظر وحاول أن تحصي ما تستطيع من بصرك -بصرك محدود- كم من الأوراق تسقط؟ كل ورقة تسقط وتتحرك بطريقةٍ ما, ورقة تذهب يمين، والورقة الأخرى تعاكسها يسار، ثم تلتقيان, وقد تصطدمان كُلّ هذه بِعلمِ الله, وأنت الآن تعيش في حيّز ضيِّق جداً جداً وعقلُك لو تابَع لأحسَست أنَّه قد أُنهك وأنت تشاهد هذا الحدث الصغير وتحاول أن تربطه بعلم الله, كيف أن الله يعلم! كيف قدّر الله هذه الورقة أن تسقط بهذه الطريقة ثم تميل يمنةً ثم تميل يَسرةً ثم تأتي الورقة الأخرى فتتقَاطع وإيَّاها ثم تعود! معنى أنك أمام أمر كبير جداً جداً فيما لو كنت ستُتابع أوراق هذه الحديقة وهي تسقط!! كيف بأوراق مدينتك!! كيف بالأوراق في جميع الأرض!! إذاً أنت أمام عظمة لا يُمكن أن تستوعبها ولا أن تُدركها .
قال تعالى : (وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ) مهما صغرت (فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) بمعنى أنّ الله قد أحصى كل هذه في هذا الكتاب المبين وهو اللوح المحفوظ , فما من شيء في هذا الكَون إلا وقد كُتب في اللَّوح المحفوظ كما أخبر الله سبحانه وتعالى ، فانظر إلى هذا الأمر وتعجَّب, كل شيء تتخيَّله قد كُتب وحُفظ ودُوِّن والله تعالى يعلم به سبحانه وتعالى.
- تفسير آية (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ)
قال في التَّفسير الميسَّر: وهو سبحانه الذي يقبض أرواحكم في الليل بما يشبه قبضها عند الموت, ويعلم ما اكتسبتم في النهار من الأعمال, ثم يعيد أرواحكم إلى أجسامكم باليقظة من النَّوم نهارًا بما يُشبه الأحياء بعد الموت, لتُقضى آجالُكم المُحدَّدة في الدنيا, ثم إلى الله تعالى معادكم بعد بعثكم من قبوركم أحياءً, ثم يخبركم بما كنتم تعملون في حياتكم الدنيا, ثم يجازيكم بذلك.والله تعالى هو القاهر فوق عباده, فوقية مطلقة من كل وجه, تليق بجلاله سبحانه وتعالى. كل شيء خاضِعٌ لجلاله وعظمته, ويرسل على عباده ملائكة يحفظون أعمالهم ويُحْصونها حتى إذا نزل الموت بأحدهم قَبضَ روحَه مَلكُ الموت وأعوانُه وهم لا يُضيعون ما أُمروا به, ثم أعيد هؤلاء المُتوفون إلى الله تعالى مولاهم الحق. ألا له القضاء والفصل يوم القيامة بين عباده وهو أسرع الحاسبين.
قل - أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: من ينقذكم من مخاوف ظلمات البرِّ والبحر؟ أليس هو الله تعالى الذي تدعونه في الشَّدائد مُتذللين جهرًا وسرًّا؟ تقولون: لئن أنجانا ربَّنا من هذه المخاوف لنكونن من الشاكرين بعبادته عز وجل وحده لا شريك له.
قل لهم - أيُّها الرسول- : الله وحده هو الذي يُنقذكم من هذه المخاوف ومن كل شدة, ثم أنتم بعد ذلك تشركون معه في العبادة غيره.
قل - أيُّها الرسول- : اللُه عزوجل هو القادر وحده على أن يرسل عليكم عذابًا مِن فوقكم كالرَّجْم أو الطُّوفان, وما أشبه ذلك, أو من تحت أرجلكم كالزَّلازل والخسف, أو يخلِط أمركم عليكم فتكونوا فِرقًا متناحرة يقتل بعضكم بعضًا. انظر -أيها الرسول- كيف نُنوِّع حُجَجنا الواضحات لهؤلاء المشركين لعلهم يفهمون فيعتبروا، وكذَّب بهذا القرآن الكفَّارُ مِن قومك أيها الرسول, وهو الكتاب الصَّادق في كل ما جاء به. قل لهم: لستُ عليكم بِحفيظٍ ولا رقيب وإنَّما أنا رسول الله أبلغكم ما أرسلت إليكم.
وفي كُلِّ خبر قرارٌ يستقر عنده, ونهاية ينتهي إليها, فيتبيَّن الحقُّ من الباطل, وسوف تعلمون -أيُّها الكفار- عاقبة أمركم عند حلول عذاب الله بكم.
وإذا رأيتَ - أيُّها الرسول- المشركين الذين يتكلمون في آيات القرآن بالباطل والاستهزاء, فابتعد عنهم حتى يأخذوا في حديث آخر, وإن أنساك الشَّيطان هذا الأمر فلا تقعد بعد تذكُّرك مع القوم المعتدين الذين تكلَّموا في آيات الله بالباطل.
تعليق الشيخ:
قال: (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ) لاحظوا أنّها تبعٌ لِذكر علم الله سبحانه وتعالى السَّابق أي هذا مثالٌ آخر لِعلمِ الله (يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ) أيّ حال النوم (وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ) استخدام لفظ الجَرح للدِّلالة على الأثر يعني وجود العمل الأثر بالنهار (ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)
/ قال:
(وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) سبقت طبعاً هذه الآية
(١)
/ قال (وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً) لو تأمَّلتم وقرأتُم في السُّنة لوجدتم الإنسان قد وُكِلَ به مجموعة من الحفظة, هؤلاء الحفظة يحفظونه من أمر الله كما ورد في سورة الرَّعد على أحد وجوه التفسير, فإذا جاء قدرُ الله الأكبر في أنَّه يُصيبه ما يُصيبه من الموت خَلَّوا بينه وبين الموت ولذا قال: (حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ) أي لا يُقصِّرون في أمرهم. لاحظوا الآن الحفظة هؤلاء لو أنت قرأت ستجد أنهم يحفظونك من أشياء كثيرة،يحفظونك من الجنّ والهوامّ والدَّواب وأنت لا تراهم فممكن أن يكون الإنسان نائم في الصحراء من شدة التَّعب ويمرّ قريباً منه الثعبان والعقرب ولكن بما أنّ الله لم يأذن لهذه الدَّواب بأن تؤذيه تجدها تمشي قريباً منه وتذهَب لا تؤذيه أبداً وقد يمرّ عليه ما هُو أكبر من ذلك، ولا يُؤذيه لماذا؟ لأنّ هناك حفظة يحفظونه من أمر الله لكنه لا يراهم .
/ قال: (ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ) طبعاً الكلام للكفار، قل أيّ لهؤلاء الكفار (قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَـذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) هنا فائدة: أهل مكة الذِّين نزل لهُم الخطاب لم يكونوا أهل بحر لكن لا يعني أنَّهم لا يعرفون البحر ولذا خاطبهم الله تعالى: (وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدِّين) معنى ذلك أنَّهم يركبون البحر ويعرفونه وإن لم يكونوا مباشرين على البحر.
/ قال: (قُلِ اللّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ) وهذا فيه تنبيه مهم جداً إلى أننَّا كثيراً ما نعمَد إلى الأسباب ونغفل عمن سبّب هذه الأسباب وهو الله سبحانه تعالى, وهذا يَدُلّ على ضعف في الإيمان .
مثال الآن: لو أنَّ واحد منَّا أُصيب مثلا بِحمَّى أو بزكام أوغيره تجده يذهب إلى الطبيب ويأخذ الدَّواء ويبدأ يستخدم الدواء وهو في حِسِّهِ أنّ هذا هو الذي سينفعه ويستعجل أخذ الدواء لأجل أن ينتفع ينسى الذي أنزل هذا المرض هو الذي يرفعه وهو الله سبحانه تعالى ، لهذا من المهم جداً أن ننتبه وأن نُربّي أولادنا على هذا العمل ، ولا يعني ذلك أننا لا نذهب إلى الطبيب لكننا نستحضر الأسباب لكن بعد أن ننسِب الشِّفاء لله تعالى (قُلِ اللّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ) وهذا خطاب طبعا للكفار.
(قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ) أيّ حاصب ..المطر.. الريح كُلَّها تأتي من فوق، (أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) مثل الزَّلال أوالبراكين (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ) (يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً) أي يجعلكم شيعاً قبيلة فلان تقاتل قبيلة فلان كما نعلم أنّه يقع أحياناً, فمثل هذا عذاب من الله سبحانه وتعالى .
/ قال: (انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ) طبعا الخطاب هنا للكفار وهو تهديد للكُفَّار لكن في قوله (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً) هذا وقعَ أيضاً على المسلمين لمَّا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالثَّلاث دعوات اُستجيبَ له دعوتان وبقيت دعوة لم تستجب له.
فما يُرى من التَّحريش بين المؤمنين اليوم ودائماً هُوَ من بقايا هذه الدَّعوة التي لم تُستجب للنَّبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبقَ لإبليس إلاّ التَّحريش بين المؤمنين.
/ قال: (وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ) آية سبق طبعا في معناها أكثر من آية قبل.
(لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) هذه آية عامة يعني كل نبأ أخبر الله عنه تعالى فإنَّ له مستقرّ (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) هذا له مستقرّ سيقع , أي خبر في القرآن له مآل فإنّه سيصل إلى مآله, أهل الجنَّة إلى الجنَّة, وأهل النّار إلى النَّار، أخبار الجنّة، أخبار النار, أخبار يوم القيامة , كل هذا هو يدخل في قوله :(لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ).
/ (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ) هذا أصل يتمسك به من يرى عدم جواز رؤية التمثيليات التِّي تستهزئ بالمؤمنين قال: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)
فلاحظ أنه وصفهم بأنهم ظالمين ولم يقل فلا تقعد معهم وإنَّما جاء الإظهار في مقام الإضمار للتنبيه على ظُلمهم ولهذا يحذر المسلم من أن يقع في مثل هذه الأمور في أن يقع في هذه الآية.
- تفسير آية (وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ)
قال في التَّفسير المُيسَّر: وما على المؤمنين الذين يخافون الله تعالى فيطيعون أوامره ويجتنبون نواهيه من حساب الله للخائضين المستهزئين بآيات الله من شيء ولكن عليهم أن يَعِظُوهم ليُمسكوا عن ذلك الكلام الباطل لعلهم يتقون الله تعالى.
واترك - أيها الرسول- هؤلاء المشركين الذين جعلوا دين الإسلام لعبًا ولهوًا مستهزئين بآيات الله تعالى وغرَّتهم الحياة الدنيا بزينتها, وذكّر بالقرآن هؤلاء المشركين وغيرهم كي لا تُرتهن نفس بذنوبها وكُفرها بربها ليس لها غير الله ناصرٌ ينصرها, فينقذَها من عذابه، ولا شافعٍ يشفع لها عنده، وإن تَفْتَدي بأي فداء لا يُقْبَل منها. أولئك الذين ارتُهِنوا بذنوبهم, لهم في النار شراب شديد الحرارة وعذابٌ مُوجع بسبب كفرهم بالله تعالى ورسوله محمَّد صلى الله عليه وسلم، وبدين الإسلام.
قل -أيُّها الرسول- لهؤلاء المشركين: أنعبد من دون الله تعالى أوثانًا لا تنفع ولا تضر؟ ونرجع إلى الكفر بعد هدايةَ الله تعالى لنا إلى الإسلام, فنُشبه - في رجوعنا إلى الكفر- مَن فَسَد عقله باستهواء الشياطين له فَضَلَّ في الأرض وله رفقة عقلاء مؤمنون يدعُونه إلى الطَّريق الصحيح الذي هم عليه فيأبى. قل -أيُّها الرسول- لهؤلاء المشركين: إنَّ هُدى الله الذِّي بعثني به هو الهدى الحق وأُمِرنا جميعًا لِنُسلم لله تعالى رب العالمين بعبادته وحده لا شريك له، فهو رب كل شيء ومالكه
وكذلك أُمرنا بأن نقيم الصلاة كاملة وأن نخشاه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهو - جل وعلا- الذِّي إليه تُحْشَرُ جميع الخلائق يوم القيامة.
والله سبحانه هو الذي خلق السموات والأرض بالحق. واذكر -أيُّها الرسول- يوم القيامة إذ يقول الله: "كن", فيكون عن أمره كَلَمح البَصر أو هو أقرب, قوله هو الحقُّ الكامل, وله الملك سبحانه وحده, يوم ينفخ المَلَك في "القرن" النَّفخة الثانية التي تكون بها عَودة الأرواح إلى الأجسام. وهو سبحانه الذِّي يعلم ما غاب عن حواسِّكم -أيها الناس - وما تشاهدونه، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، الخبير بأمور خلقه. والله تعالى هو الذِّي يختص بهذه الأمور وغيرها بدءًا ونهاية، نشأة ومصيرًا، وهو وحده الذي يجب على العباد الانقياد لشرعه, والتسليم لحكمه، والتَّطلع لرضوانه ومغفرته.
تعليق الشِّيخ:
(وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ) لمَّا ذكر أوأمر بالإعراض عن الذين يخوضون في الحديث , من ذكّرهم بالله , قال ما على أمثال هؤلاء ( الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَـكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) أي لعلّ هؤلاء القوم الخائضين يتقون , فمن اتقى الله مع هؤلاء الخائضين ونَصَحَهم فليس عليه شيء وما يقوله فإنه ذكرى لهؤلاء لعلهم يتقون.
/ قال: (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِه) أي بالقرآنِ (أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ) أن تُحبَس وتُرتهن (بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ) (تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ) هي كقوله: (كل نفس بما كسبت رهينة).
/ قال: (وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ) فإذاً الخطاب هذا كله لأهل الكفر .
/ (قُلْ أَنَدْعُو) قل للكفار (أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا) يعني لاحظ الآن هذا كأنه رجل استهوته الشياطين أصابه المسّ , أصابه الجنّ وهو ضالّ في الصحراء (لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا) ولكنه لا ينتصح ولا يأتي لهم (قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) أي نستسلم الاستسلام التَّام لله سبحانه وتعالى .
/ ثم قال: (وَأَنْ أَقِيمُواْ الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوَرِ) لاحظُوا يُنفخ في الصُّور لم تأتي في القرآن إلا مبينة للمفعول أو للمجهول -يُنفخ في الصور،نُفخ في الصَّور- كلها جاءت على هذا النَّسق.
وفيها دلالة على أنّ العناية بالنَّفخ في الصور، والصَّور هو: البوق الذي يكون مثل القمع فدلالة على العناية بالنفخ في الصور دون العناية بمن ينفخ وإن كان النَّافخ إسرافيل فهو معلوم من الآثار النَّبوية.
/ قال: (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) ولعلَّنا نقف عند هذا الحدّ من هذه الآيات .
طبعاً الآيات مررنا عليها مروراً سريعاً لِضِيق الوقت .
- وقفة عند قوله تعالى: (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ)
يقول الإمام الطَّبري: "اختلف أهل التَّأويل في تأويل قوله: (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ) فقال بعضهم معناه هؤلاء المُشركون المُكذِّبُون بآيات الله ينهون النَّاس عن اتِّباع محمّد صلى الله عليه وسلم والقَبُول منه وينأَون عنه، يتباعدون عنه".
• ثم قَال "ذِكرُ من قال ذلك وأشَارَ إلى الرِّواية من طَريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس قال: ينهون النَّاس عن محمد أن يؤمنوا به، وينأَون عنه يعني يتباعدون عنه.
• ثم أورد رواية أخرى عن السُّدي قال: أن يُتبَّع محمد ويتباعدون منه.
• رواية أخرى عن ابن عباس من طريق عطية العَوفي قال : لا يَلقونه ولا يدَّعون أحداً يأتيه يعني محمداً صلى الله عليه وسلم .
• رواية أخرى عن الضَّحاك قال: وهم يَنهون قال عن محمد صلى الله عليه وسلم .
• قال عن قتادة قال: جمعوا النَّهي والنأي التباعد .الآن انتهى القول الأول .
• وقال بعضهم ينهون عن القرآن أن يُسمع له ويُعمل بمَا فيه .
القول الأول ينهون عن النبي صلى الله عليه وسلم
القول الثاني ينهون عن القرآن .
• ووردت رواية عن قتادة قال ينهون عن القرآن وعن النَّبي صلى الله عليه وسلم وينأون عنه ويتباعدون عنه .
• رواية أخرى عن مجاهد قال: ينهون عنه، قال : قريش عن الذِّكر , وينأون عنه يتباعدون.
• رواية أخرى عن مجاهد بنفس المعنى.
• ورواية أخرى عن قتادة بنفس المعنى يَنهون عن القُرآن وعن النَّبي صلى الله عليه وسلم .
• عن أبي زيد قال ينهَون عن أذى محمد صلى الله عليه وسلم وينأون عنه ويتباعدون .
• عن وكيع قال نزلت في أبي طالب كان يَنهى عن مُحمَّدٍ أن يُؤذى وينأى عمَّا جاء به أن يُؤمن به .
• عن حبيب بن أبي ثابت قال حَدَّثني ابن عباس قال نزلت في أبي طالب, رواية أخرى أيضاعن حبيب عن ابن عبّاس أنّها نزلت في أبي طالب، ورواية أخرى القاسم بن خيبرة أنها نزلت في أبي طالب , ورواية أخرى أيضاً عن العباس أنها نزلت في أبي طالب , ورواية أخرى عن القاسم نزلت في أبي طالب , وعن حبيب قال ذاك أبو طالب.
الآن عندنا ثلاث أقوال:
• القَول الأول ينهون عن القرآن .
• القول الثاني ينهون عن النبي صلى الله عليه وسلم .
• القول الثالث ينهون أي المراد به أبي طالب.
الآن إذا أردنا أن نحرر المعنى من جهة السياق :
في آية 26 (وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ) وقبلها (ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ) الآن السياق في من؟ في الكفار، أول الصفحة (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ) يعني الآن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة , وعن القرآن من جهة والخِطاب عن المشركين, لاحظوا الآن الطبري -رحمه الله تعالى- كيف سيختار المعنى , طبعا في التفسير الميسر اختاروا: وهم ينهون عن النبي صلى الله عليه وسلم وينأون عنه. يقول الطبري -رحمه الله تعالى- في هذا: "وأَولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال تأويل وهم ينهون عنه عن اتِّباع محمد صلى الله عليه وسلم مَن سِواهم من النَّاس وينأون عن إتِّباعه , وذلك أن الآيات قبلها جرت بذكر جماعة المشركين العادلين به والخبر عن تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعراض عما جاءهم به من تنزيل الله ووحيه, فالواجب أن يكون قوله (وهم ينهون عنه ) خبراً عنهم إذ لم تأتنا ما يدل على انصراف الخبر عنهم إلى غيرهم . بل ما قبل هذه الآية وما بعدها ، يدل على صحة ما قلنا ، من أن ذلك خبرُ عن جماعة مشركي قريش قوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، دون أن يكون خبرا عن خاصٍّ منهم .
وإذ كان ذلك كذلك ، فتأويل الآية : وإن يرى هؤلاء المشركون يا محمد كُلَّ آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقولون : إنَّ هذا الذي جئتنا به إلاّ أحاديث الأولين وأخبارهم ، وهم ينهون عن استماع التَّنزيل ، وينأون عنك فيَبعدُون منك ومن اتَّباعك (وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ..) إلخ الآية.
هذا ترجيح الطَّبري .
طيب الآن الطَّبري ردّ أحد الأقوال وهو أنها نزلت في أبي طالب لأنه قال عن جماعةِ مشركي قوم رسول الله دون أن يكون خبرا ًعن خاصّ منهم من هو؟ أبو طالب .
لو كان خبراً عن خاصٍّ منهم يكون من أيِّ أنواع العموم؟ لو كان خبراً عن خاصٍ منهم عن أبي طالب, وهم ينهون عنه وينأون عنه, الضَّمير ضمير الجمع والمراد واحد يسمى العامّ الذي أريد به الخُصوص مثل : (الذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ) فإذاً هو الآن اعترض على من قال أنه أبو طالب.
لو قلنا إنّ أبا طالب هو مثال لمن ينهى وينأى يصح أو لا ؟ يَصح , فيكون قول معتبراً من باب المثال , فالذين ينهون وينأون هم المشركون , طيب ينهون من؟ وينأون عن من؟ ينهون عن النبي أو القرآن؟ بناء على ترجيح الطبري ينهون عن استماع القرآن وينأون عن النبي صلى الله عليه وسلم , الضمير واحد وهم ينهون عن النبي وينأون عنه , أو ينهون عن القرآن وينأون عنه , الطّبري اختار المُشاركة بينهما لكن لاحظ الآن لمّا قلنا ينهون عن النبي وينأون عنه من لازِم ذلك أنهم ينهون عما جاء به أو لا؟
طيب ينهون عن القرآن وينأون عنه من لازم ذلك أنهم ينهون عن النبي صلى الله عليه وسلم وينأون عنه أو لا؟
فإذاً قولان متلازمان فاختيار أحدهما لا يُبطِل الآخر وبناءً عليه: من ذكر أنه القرآن فصواب ومن ذكر أنَّه الرسول صلى الله عليه وسلم فصواب ، ومن قال أنه أبو طالب على سبيل التمثيل فصواب . لأنَّ كل هذه الأقوال في النِّهاية عندنا تكون من باب اختلاف التَّنوع.
نقف عند هذا الحَدّ كان بودي أننّا نربط قضايا المَوضوعات جدال المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، قضايا التَّحليل والتَّحريم. ربط بالتوحيد لكن الوقت كما تلاحظون انتهى ولعل الله ييسر في لقاء قادم.
لتحميل الملف الصوتي:
____________________________
مصدر التفريغ ملتقى أهل التفسير (بتصرف يسير)